يمكن الآن إجراء تشخيص سريع وحساس للإنتان باستخدام التضخيم ثنائي الطور في مصفوفة الدم المجففة
تؤدي عدوى مجرى الدم (BSIs) وتسمم الدم إلى ارتفاع معدلات المراضة والوفيات، لا سيما لدى المرضى ذوي الحالات الحرجة وحديثي الولادة. يمكن تحسين نتائج المرضى بشكل ملحوظ بإعطاء المضادات الحيوية خلال ثلاث ساعات من ظهور الأعراض الأولية، إلا أن طرق التشخيص الحالية تستغرق وقتًا أطول بكثير لتشخيص عدوى مجرى الدم/تسمم الدم.
المعيار الذهبي الحالي للتشخيص هو إجراء مزرعة دم – والتي تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام للحصول على نتيجة سلبية – متبوعة بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). كما يؤدي عدم وجود تشخيص دقيق وفي الوقت المناسب إلى إعطاء مضادات حيوية واسعة الطيف، مما يساهم في ظهور مسببات الأمراض المقاومة للأدوية.
لمعالجة بطء ظهور النتائج والتحديات الأخرى المتعلقة باختبارات التشخيص الحالية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اتبع باحثون من إلينوي نهج معالجة الدم الكامل. في أوائل أكتوبر، نُشرت دراسة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، تصف وحدة معالجة دم مزودة بشبكة مسامية من الموائع الدقيقة والنانوية داخل مصفوفة دم مجففة. داخل هذه المصفوفة، يمكن للبوليميراز الوصول إلى الحمض النووي وبدء “التضخيم ثنائي الطور”، حيث تبقى خلفية الهيم محصورة في الطور الصلب بينما تُثري الأمبليكونات في السائل العلوي الشفاف، مما يسمح بكشف التغيرات الفلورية بحساسية جزيء واحد.
قام الباحثون بالتحقق من صحة تحليلهم على 63 عينة سريرية، وحددوا جميع العينات بدقة دون أي نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة، مقارنةً بالمعيار الذهبي، مما أدى إلى حساسية وخصوصية 100%. من بين مسببات الأمراض العديدة التي تمكنوا من اكتشافها باستخدام 0.8 مل إلى 1.0 مل فقط من حجم الدم الابتدائي، بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية موجبة الجرام المقاومة للميثيسيلين والحساسة له (MRSA وMSSA)، وبكتيريا الإشريكية القولونية سالبة الجرام، والمبيضة البيضاء (فطريات الخميرة الانتهازية). والأهم من ذلك، أن هذا النهج ثنائي الطور الخالي من المزارع قلل من الوقت اللازم لتشخيص عدوى البكتيريا الجرثومية/إنتان الدم من أكثر من 20 ساعة إلى أقل من ساعتين ونصف، مما يُحدث فرقًا كبيرًا في الحالات محدودة الموارد وللمرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى قرارات علاجية عاجلة.
مقتبس من مقال الدكتورة زهراء شروقاي على موقع clinicallab




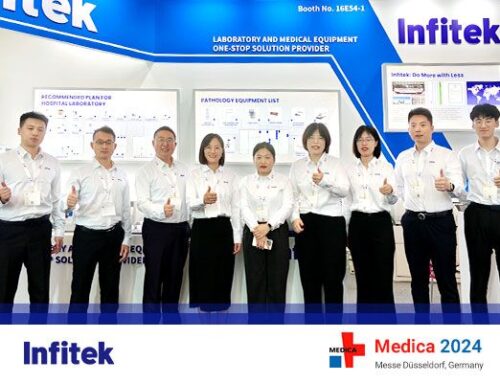

Get Social